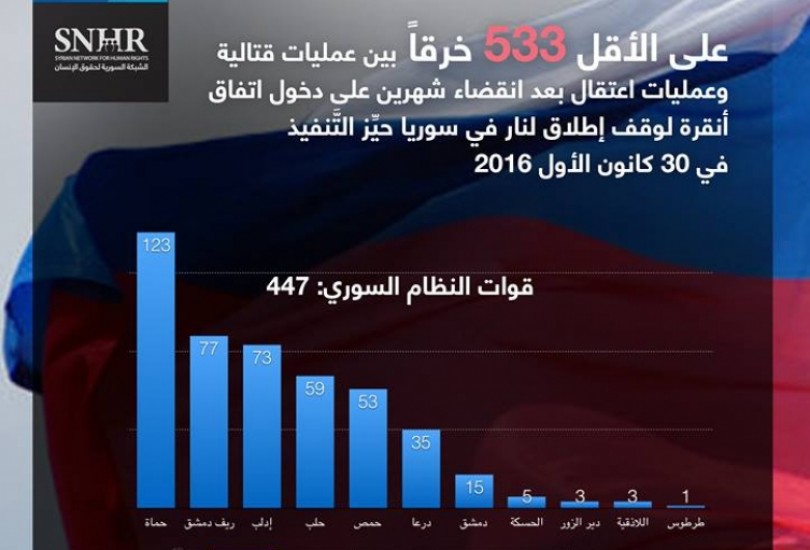ليست الخلافات التركية ــ الأميركية الحالية سوى امتداد للخلافات الرئيسية بين الجانبين، والتي أخّرت توقيع اتفاق "تدريب وتسليح قوات المعارضة السورية المعتدلة" بحسب المصطلحات الأميركية متمثلة بالخلاف حول استراتيجية ضرب "داعش". أرادت أنقرة من الاستراتيجية أن تكون حلاً شاملاً يرتكز على نقطتين: الأولى، إنهاء الحرب السورية والتي تستوجب، بحسب أنقرة، إسقاط النظام السوري وتشكيل حكومة انتقالية تمهيداً للانتخابات. أما النقطة الثانية، فتكمن في الضغط على بغداد لتحسين أوضاع العرب السنة ومشاركتهم بشكل أفضل في حكم وإدارة العراق، مع الحفاظ على وحدة أراضي البلدين.
أما بالنسبة لواشنطن، فبدت استراتيجيتها بعيدة تماماً عن ذلك، ولم تكن تهتم سوى بضرب "داعش"، معتبرة أن المعركة الأساسية مع التنظيم هي في العراق، لتجد الإدارة الأميركية نفسها عالقة بعد ما يقارب العام على تشكيل التحالف ضد "داعش". فلم يحقق التحالف أي تقدم ملموس على الأرض، ولا يزال "داعش" يتمتع بقدرة كبيرة على توجيه الضربات وشن المعارك، حتى إنه وسّع مناطق سيطرته.
في غضون ذلك، تمّ الدفع بأحد المقربين من أردوغان، وجدي غونول، لتسلم حقيبة وزير الدفاع، خلفاً لعصمت يلماز الذي تسلم رئاسة البرلمان. وبينما تستمر التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية التي تؤكد بأن موقفها لم يتغيّر تجاه تكوين منطقة عازلة أو آمنة ومنطقة حظر طيران، يستمر الجيش التركي في حشد قواته على الحدود التركية، تمهيداً لعملية ما في الأراضي السورية لحماية النفوذ التركي وقطع الطريق على "الاتحاد الديمقراطي" للتقدم غرباً باتجاه ريف حلف الشمالي والشرقي، وبالتالي تكوين ممر لـ"العمال الكردستاني" بكل ما يشكله ذلك على الأمن القومي التركي.
وفي حين أعاد المسؤولون الأتراك ترتيب قائمة الأعداء، لم يعد النظام السوري الضعيف حالياً على رأس القائمة، بل بات كل من "الاتحاد الديمقراطي" و"داعش" العدو الأول. جاءت تصريحات رئيس الحكومة الانتقالية أحمد داود أوغلو الأخيرة وكأنها تهدئة للموقف، عندما أكد يوم الجمعة في مقابلة تلفزيونية، أنّ "لا خطط فورية للتدخل في سورية، ينبغي ألا يتوقع أحد أن تركيا ستدخل سورية غداً أو في المستقبل القريب". لكنه أشار إلى أن بلاده لن تنتظر إلى الغد في حال تم تهديد أمنها القومي. هذا التهديد يمكن تفسيره بنقطتين: توغّل "الاتحاد الديمقراطي" غرب الفرات باتجاه جرابلس، و/أو سقوط أعزاز في يد "داعش".
جاء كلامه، في الوقت الذي بدا فيه برنامج تدريب وتسليح ما يسمى أميركياً "قوات المعارضة السورية المعتدلة" متعثراً هو الآخر في ظل اعتراف وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، أخيراً بصعوبة بناء قوة قتالية قوية في بلد يفتقر إلى وجود قوة أميركية عسكرية على أرضه.
في هذا الوقت، طرح معهد "بروكينغز" أخيراً ورقة بعنوان "تفكيك سورية: استراتيجية جديدة لحرب أميركا الميؤوس منها"، إذ بدت هذه الورقة محاولة لإخراج أميركا من مأزقها في سورية ومن مأزقها مع حلفائها في كل من الخليج وتركيا، خصوصاً في ظل الحديث المتزايد عن نية الأردن أيضاً في إقامة منطقة عازلة في جنوب سورية لحماية نفسه من الجهاديين.
وتعتمد الخطة الجديدة على مساعدة ما تسميها "العناصر المعتدلة" على إنشاء مناطق آمنة داخل سورية، بمساعدة القوات الأميركية والسعودية والتركية والبريطانية والأردنية، ليس فقط عبر الجو، لكن على الأرض من خلال القوات الخاصة. وستشكل هذه المناطق الآمنة ملاجئ للنازحين السوريين، التي يمكن أن تتوفر فيها الإغاثة الإنسانية، وإعادة فتح المدارس، وتجنيد وتدريب القوات المقاتلة من المعارضة، بمساعدة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وتختلف هذه الخطة عن الاستراتيجية الحالية في ثلاث نقاط رئيسية: أولاً: سيتم تحديد الفكرة بوضوح باعتبارها الهدف المعلن للولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يقلل من الخلافات مع المعارضة والجهات الإقليمية الداعمة لها كتركيا والسعودية، كما ستساعد على تبديد الشكوك بأن واشنطن مقتنعة بأن حكومة الأسد الآن هي "أهْوَن الشرّين". ثانياً: سيتم فحص عناصر المعارضة التي سيتم تدريبها وفقاً لمجموعة مختلفة من المعايير. وفي حين أنّه لا يزال يُنظر إلى مجموعات السلفية الجهادية كإيديولوجيات متطرفة، فإن التعاون معها لن يُنظر إليه باعتباره أمراً شائناً، وخصوصاً أنّ هذا التعاون يمكن أن يكون وسيلة ضرورية للبقاء على ساحة المعركة السورية المعقدة. ثالثاً: ستنتشر فرق الدعم المتعددة الأطراف التي ترتكز على فصائل القوات الخاصة وقدرات الدفاع الجوي في أجزاء من سورية بمجرد قدرة عناصر المعارضة على تحصين مناطق سيطرتها.
هذه الخطة، سيتم توجيهها ضد "داعش" والأسد أيضاً بحسب "بروكينغز"، لكن لن تسعى أميركا إلى الإطاحة بالأخير بقدر حرمانه من السيطرة على الأراضي التي يطمح في حكمها مرة أخرى. لن يكون الأسد هدفاً عسكرياً في ظل هذا المفهوم، ولكن المناطق التي يسيطر عليها حالياً ستكون هي الهدف، وإذا تأخر الأسد في قبول صفقة نفيه، فإنّه قد يواجه مخاطر مباشرة تهدد حكمه وشخصه أيضاً.
وتبدو العبارة الشهيرة التي أطلقها وزير الخارجية الأميركية جون كيري بداية العام 2014، خلال مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد في باريس، بينه وبين نظيره التركي، حينها، أحمد داود أوغلو، وحرفيتها أنه "علينا تهدئة العلاقات البينية، ويجب على الطرفين ألا يركزا على المواضيع الخلافية"، سارية المفعول حتى اليوم وإشارة واضحة إلى مدى جدية الخلافات بين أنقرة وواشنطن، منذ ذلك الوقت. كما أنّها توضح الاستراتيجية التي اتبعها الطرفان في إدارة ملفات الشرق الأوسط ويأتي على رأسها الملف السوري، والتي تمثلت "بغض النظر عن الخلافات والتركيز على الجوانب المشتركة"، لتنفجر الخلافات أخيراً، بعد سيطرة حزب "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني) على منطقة تل أبيض الحدودية بدعم وغطاء من طيران التحالف ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، على الرغم من معرفة واشنطن ما قد يثيره ذلك من مخاوف وهلع في أنقرة.
يؤكد مراقبون أن العلاقات التركية، بعد انتهاء الحرب الباردة، تغيّرت بشكل واضح. وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيلغي في إسطنبول، إلتر توران، فإن العلاقات بين أنقرة وواشنطن أخذت منحى مختلفاً، ولم تعد علاقة التبعية من تركيا للولايات المتحدة. يؤكد توران أنّ "الربيع العربي كان فرصة مناسبة لإعادة تشكيل أرضية مشتركة للجانبين، بعدما كان المفصل الرئيسي في تغيير العلاقات بينهما عام 2003، عندما رفض البرلمان التركي استخدام الولايات المتحدة للأراضي والقواعد العسكرية التركية في غزو العراق، ونتج عنها، كما يطلق عليها الإعلام التركي "حادثة الشُوال"، عندما قامت قوات خاصة أميركية باعتقال عدد من عناصر القوات الخاصة التركية في إقليم كردستان العراق بشكل مهين".